أوديب الفكر وسؤال الرغبة عند دولوز
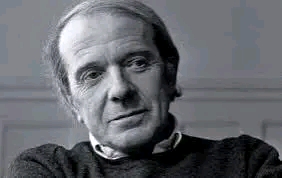
- حسن أوزال
طيلة اشتغاله الفلسفي، عمل دولوز على تفكيك ما يسمّيه بـ”أوديب الفكر المحض” وتقويضه؛ مؤكّدا أنّ الأوديبات -هكذا بالكثرة- توجد في كلّ مكان: إذ ليس ثمّة “أوديبات عائلية” فحسب، بل هنالك أيضا “أوديبات علمية”، ثمّ الأوديب الـ”فلسفيّ” الذي هو الكوجيطو أي الآلة الأوديبية التي تشتغل على مستوى الفكر. وهي ما نسمّيه بالنزعة الإثنينية le dualisme. ذلك أنّ الإثنينية هي ما يعرقل الفكر ويحول دون التفكير. فهي تروم دوما نفي جوهر الفكر، هذا الجوهر الذي يقضي على كون الفكر صيرورة. بدهي إذن أنّ الإثنينية بحسب دولوز لا تقوم إلا على هذا النوع من الاختزال والتسطيح الذي تُلْحِقُه بكلّ مقوّلات الفكر، بواسطة هذا الجهاز التأمّليّ الأوديبيّ الذي يجعل الملفوظ من جهة أولى موصولا بذات وفي الآن نفسه، يجعل الذات منشطرة إلى “ذات الملفوظ” و”ذات التلفّظ”.
وفي إطار كهذا، يُعاد التفكير في الذات من حيث هي سيّدة الخطابات ومصدر إنتاجها. إذ مهما تعدّدت هذه الخطابات وتناقضت، يستحيل ألا تُحيل على المرجع الأصل والنبع الصافي الذي هو الذات. ففضلا عن التحليل النفسي، نتاج الفكر الغربيّ، الذي يوقعنا في فخّ مؤدّاه أنّ الخطابات كلّها فردية، يلزمنا العلم بأنّ شكل الخطابات الفردية ومنطقها قد تمّ تثبيتهما أساسا، بواسطة الكوجيطو. بحيث يرى هذا الأخير أنّ إنتاج الخطابات، إنّما يتمّ من خلال الذات من حيث هي ذات مُعَيَّنة ومُحَدَّدة. فالكوجيطو يفيد أوّلا، أنّ كلّ خطاب هو نتاج ذات، ويعني ثانيا بأنّ كلّ خطاب يَشْطُرُ الذات التي تُنْتِجُه لِتَنْوَلِد من ثمّة ذاتان هما أساس قيام مبدأ الكوجيطو: ذات التلفّظ وذات الملفوظ. يعلّق دولوز على خطورة هذه النزعة الإثنينية، منبّها إلى أنّه ليس ثمّة إلا شكل واحد للتفكير: أي أن نفكّر على نحو واحديّ moniste أو على نحو متعدّد pluraliste. وهما معا نفس الشيء.
لكنّ العدوّ الوحيد للفكر إنما هو اعتبارهما اثنين. وإذا كانت الواحدية والتعددية هما الشيء نفسه، فكلّ مقابلة أو إقامة تعارض ما بينهما هي أساس الإثنينية: أصل الإثنينية إذن يتجلّى أكثر ما يتجلّى في المضيّ نحو القول بأنّ ثمة شيئا لا يمكنه أن يكون إلا واحدا، وأنّ ثمّة مقابل الشيء ونقيضه، شيء آخر هو بمثابة المتعدّد. وما يُشار إليه كواحد هو بالضبط ذات التلفّظ، أمّا ما يشار إليه كمتعدّد فهو دوما ذات الملفوظ. لكنّ الخروج من هذا التقابل ما بين الواحد والمتعدّد، ممكن ويبدأ من تلك اللحظة التي يكفّ فيها الواحد والمتعدّد عن أن يكونا نعتين، تاركين المجال رحبا لقيام اسم: التعدّد؛ فليس ثمّة إلا تعدّديات multiplicités. بدهي إذن أنّ اللحظة التي يَحُلُّ فيها اسم التعدّديات، محلّ الواحد والمتعدّد، هي اللحظة ذاتها التي يفقد فيها الاثنان معا كلّ معنى، ومعهما أيضا ذات التلفّظ التي تَنْحَلُّ وتذوب في ذات الملفوظ. إلا أنّه، حيثما نغادر مجال التعدّديات، نسقط ثانية في مطبّ الثنائيات، أي في مجال اللا فكر la non pensée ونكون قد وَدَّعْنا فضاء الفكر باعتباره صيرورة.
وتوضيحا لفداحة الخسارة في هذا السياق، يدعونا دولوز إلى استحضار تاريخ الرغبة. ما دام التفكير والرغبة عنده شيء واحد. إلا أنّ ثمّة نزوعا ارتكاسيّا يروم باستمرار تحريف الرغبة وفصلها عن الفكر: ذلك أنّ أفضل طريقة للحيلولة دون اعتبار الرغبة فكرا ورفض كونها صيرورة، هي بالطبع وصلُ الرغبة بالنقص. وتلكم أوّل لعنة أصابت الرغبة، إنّها أوّل لعنة مسيحية كَلَّفَت الرغبة، ثمنا باهظا وبدأت مع الإغريق. أمّا ثاني لعنة فهي النظر إلى الرغبة من حيث هي ما يمكن إشباعه بفضل اللذّة le plaisir واعتبار أنّ الرغبة بالتالي، في ارتباطها بالمتعة la jouissance قابلة لأن تُقَال وأن يُعَبَّر عنها. في حين تقوم ثالث لعنة على أساس النظر إلى الرغبة من حيث هي حتمية طبيعية أو عفوية. هكذا تنشأ حلقة غريبة من قبيل رغبة – لذّة – متعةdésir –plaisir-jouissance هي مرّة أخرى أسلوب جهنّميّ لتصفية الحساب مع الرغبة. إنّ فكرة اللذّة فكرة فاسدة بحسب دولوز، ويكفينا بحسبه استحضار نصوص فرويد حيث يتحدّث عن الرغبة – اللذّة معتبرا الرغبة قبل أيّ شيء آخر طاقة لا تُحْتَمل. طاقة مزعجة، ينبغي التخلّص منها ما أمكن عبر الإنفاق. وهذا الإنفاق الذي هو اللذّة عينها هو ما به نلوذ بالراحة ونستعيد السكينة والطمأنينة أي حالة الأتراكسيا؛ إلى أن تَنْوَلِد فينا الرغبة من جديد فنكون في حاجة إلى إنفاق جديد. وعلى هذا النحو ترتسم معالم الدائرة التيولوجية بأقواسها الثلاثة، لتأخذ الرغبة منحى متعاليا: فإذا كان القوس الأوّل هو ما يمكننا التدليل عليه بـ”رغبة-نقص”، فالقوس الثاني هو ما يمكننا أن نرمز إليه بـ”رغبة- لذّة” أمّا القوس الثالث فهو ما يمكننا تمثيله بـ”رغبة- متعة”.
هكذا تتشكّل معالم الرغبة -على نحو ما- بحسب هذه الدائرة الدينية لتبدو كقصدية، في حاجة دائمة إلى ما ينقصها، مُوَجَّهة من لدن المتعالي مثلما تُقَاس بحسب وحدة مفارقة لها ومختلفة عنها هي اللذّة والأورغازم، اللذان يضمنان لها إنفاقها. ومن جهة ثانية وسعيا منه لتوضيح التمييز القائم ما بين اللذة والمتعة، يعود بنا دولوز إلى مؤلّف “رولان بارت” بعنوان : “لذّة النص”؛ حيث يُعَرِّف بارت نص اللذة باعتباره: “ذلك الذي يرضي ويفعم ويغبط، ذلك الذي يأتي من صلب الثقافة ولا يقطع صلته بها، وهو نص يتوقّف على التعاطي للقراءة على نحو مريح”، أمّا نص المتعة “فهو ذلك الذي يجعلك تتيه، إنّه نص منهك، يخلخل القواعد الثقافية والتاريخية والسيكولوجية للقارئ، مثلما يزعزع تماسك أذواقه وقيمه وذكرياته… “والحال أنّها ذاتٌ مفارقة لزمانها تلك التي تمسك بكلا النصين في مجالها، حائزة على عنان اللذّة والمتعة معا، ذلك أنّها تشارك في الوقت نفسه، وعلى نحو متناقض، في المتعوية المتأصّلة في كلّ ثقافة وفي هدم هذه الثقافة. إنّها تستمتع بتماسك أناها، وثمّة لذّتها؛ وتروم فقدانه، فقدان أناها، وثمّة متعتها. إنّها ذات منشطرة مرّتين، ومنحرفة مرّتين. “إلا أنّ بارت ولحسن الحظّ يصل به الأمر إلى القول في نصّ آخر من مؤلّفه المذكور:”أليست اللذّة إلا مجرّد متعة دنيا والمتعة إلا لذّة قصوى؟ لا. إنّ الأمر ليس يتعلّق بكون الأولى أقوى من الثانية ولا بكون الثانية أقلّ قوّة من الأولى، أكثر ممّا يتعلّق بكونهما تختلفان من حيث الطبيعة.
وإذا قلنا إنّ الرغبة والمتعة هما قوّتان متوازيتان لا يمكنهما أن تتقاطعا، وأنّ بينهما أكثر من حرب ولا تواصل ؛ حينئذ وجب علينا أن ندرك بأنّ التاريخ، بما هو تاريخنا، ليس يطبعه الهدوء ولا هو حتى بعقلانيّ، وبأنّ نص المتعة يتمظهر فيه دوما على نحو معيب وأعرج؛ فهو دوما مفعول قطيعة ونتاج إثبات. ثمّة فرق شاسع إذن بحسب دولوز، مابين الرّغبة واللذّة والمتعة بل لا صلة بتاتا للأولى بالاثنتين، ويكفينا توضيحا لهذا الأمر أن نستحضر معه هذا الكتاب الشهير بعنوان: “الحياة الجنسية في الصين القديمة” لـ”فان غوليك “حيث تُعْرَض الرغبة دون أن تكون في صلة بأيّ متعال، فهي هنا ليست موصولة بأيّ نقص ولا تقاس بأيّة لذّة ولا تُتَجاوز من لدن أيّة متعة. إنّ الرغبة هنا إن كانت لا تفتأ تُعرض كصيرورة، فلا لشيء إلا لأنّ مشكلة الصينيين ليست هي مشكلة الغرب الذي يروم الفصل مابين الجنسانية والإنجاب، بل هي كيف يفصلون ما بين الجنسانية والأورغازم: إنهم يتصوّرون أنّ اللذة والأورغازم ليسا أبدا نهاية صيرورة بل هما قطع له أو تهييج. فالاثنان يقومان على نفس الشيء، لأنّهما لحظتا توقّف تتطلّبان تشغيلا جديدا لعملية الصيرورة. يتوفّر الصينيون على تصوّر للطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية يقضي بالنظر إلى الطاقة الأنثوية كما لو كانت غير قابلة للاستنفاد، خلافا للطاقة الذكورية التي تُسْتَنْفَدُ.
من ثمّة فالرجل، على كلّ حال هو من يأخذ شيئا ما من طاقة المرأة التي لا تستنفد. أو بالأحرى أنّ كلّ واحد منهما يتحصّل على قدر من طاقة الآخر. المسألة هنا هي مسألة تيّارات les flus. بحيث يجب على التيّار الأنثويّ أن يصعد عبر مسالك محدّدة بدقّة، متبعا خطوط التيّار الذكوريّ،على طول العمود الفقريّ، وصولا حتى الدماغ حيث تقوم الرغبة على نحو محايث كصيرورة. إننا نتلقّى تيّارا، ونمتصّ تيّارا، ليتحدّد حقل محايثة للرغبة، نسبة إليه تكون اللذة والأورغازم والمتعة بمثابة لحظات تأجيل حقيقية أو توقّفات. أي أنّها كلها ليست في شيء إشباعا للرغبة بل العكس: هي تهييج لتلك الصيرورة التي تُخْرِج الرغبة من نطاق محايثتها الخاصة أي من إنتاجيتها الخاصة.
في سياق هذا التصور تفقد الرغبة تِبَاعا كلّ علاقة تصلها بالنقص أو اللذّة والأورغازم أو بالمتعة. إنها تُتَصَوَّر كـ عملية”إنتاج تيّار”، تؤدّي إلى قيام حقل للمحايثة. وكلّ حقل محايثة يعني تعدّدية ما une multiplicité، تعدّدية معها يغدو كلّ انشطار للذات، إلى ذات التلفظ وذات الملفوظ، أمرا مستحيلا، مثلما يستحيل أيضا وجود ذاتُ المتعة وذات اللذّة، مادمنا قد حدّدنا، ضمن آلتنا الدائرية السالفة الذكر، ذاتَ التلفّظ باعتبارها ذات المتعة المستحيلة، وذاتَ الملفوظ باعتبارها ذات اللذّة أو الذات الساعية وراء اللذّة، أمّا الرغبة باعتبارها نقصا فهي انشطار الاثنين. “إنّ الخطأ الذي يرجع الرغبة إلى قانون النقص هو نفسه الذي يرجعها إلى قاعدة اللذّة. فاستمرارنا في إلحاق الرغبة باللذّة، لذّة ينبغي الحصول عليها، يجعلنا ندرك في الوقت ذاته أنّ الرغبة ينقصها أساسا شيء ما، لدرجة أنّنا نضطرّ من أجل القطع مع هذه التحالفات الجاهزة مع رغبة- متعة- نقص إلى استعمال حيل غريبة وكثير من الإبهام”.(1)
إنّ سؤال الرغبة بنظر دولوز ليس هو “ما معنى الرغبة؟ “بل هو كيف يشتغل هذا الذي نسمّيه رغبة؟ كيف تشتغل الآلات الراغبة، آلاتُك، آلاتِي… كيف تنتقل من جسد إلى آخر، كيف تقترن بالجسد بدون أعضاء، وكيف تُوَاجِه نظامها، بالآلات الاجتماعية؟”(2) ذلك أنّ الرغبة في كلّ منحى من مناحيها ثورية، لا تُخْتَزل في النزعة العائلية le familialisme التي ظلّت حُلم الطبّ العقليّ ولا يمكن إلحاقها بالنقص، سليل التعالي الدينيّ ولا ردفها باللذة والمتعة باعتبارهما إيقافا لمجراها. فالرغبة توليف لسرعات وتباطؤات وهي دوما لا تفتأ تقترن بأشياء أخرى هي ما يجسّد امتداداتها: فهي إذن كلّ شيء. يكفينا من أجل ذلك أن ندرك أنّها هي التي تُجَرِّب ولا تتطلّب تأويلا : فالنوم رغبة. التفسّح رغبة. الرسم والكتابة رغبة. الربيع والصيف والشتاء رغبة. الطفولة والشيخوخة رغبة.
كلّ شيء يكاد يضحي رغبة طالما سمحنا لتنسيقاتها بالنشوء خارج أنظمة السلطة وعملياتها ذات مفعول حصريّ un effet répressif. فأنظمة السلطة إذ تكره الرغبة، لا تعمل على سحقها أو القضاء عليها من حيث هي معطى طبيعيّ، أكثر ممّا تعمل على سحق سنن تنسيقات الرغبة les pointes des agencements du désir: ولا أدلّ على ذلك من نظام الجنسانية مثلا، الذي ينقص ويخفض من قدر الجنسانية عند مستوى الجنس، سيما عند اختلاف الأجناس. ليس للرغبة إذن بحسب دولوز من أصل ولا غاية، مادام أنها ما يقوم ضدّ كل أصل أصل، وغاية غاية. إنها ما ينطلق من الوسط أي هذا البين بين، دائم الانفلات، والذي علينا رصد تحركاته وانتقالاته على مستوى ما أسماه بـ”خطوط الهروب”. تلك التي تسمح لكلّ منّا بتدبير حربه الخاصة، وإيجاد آلته الحربية الكفيلة بإنقاذ حياته من أخطبوط الأَوْدبة : أَوْدبة الفكر والرغبة معا.
الهوامش:
(1)جيل دولوز-كليربارني : حوارات في الفلسفة والأدب والتحليل النفسي والسياسة، ترجمة عبد الحي أزرقان-أحمد العلمي، إفريقيا الشرق، 1999، ص.127.
(2)Gilles Deleuze et Félix Guattari,L’ANTI-ŒDIPE,Capitalisme et Schizophrénie 1,cérés Ed.P.127.




